مقال بعنوان: ماهية الشرطة الإدارية ودورها في حماية النظام العام
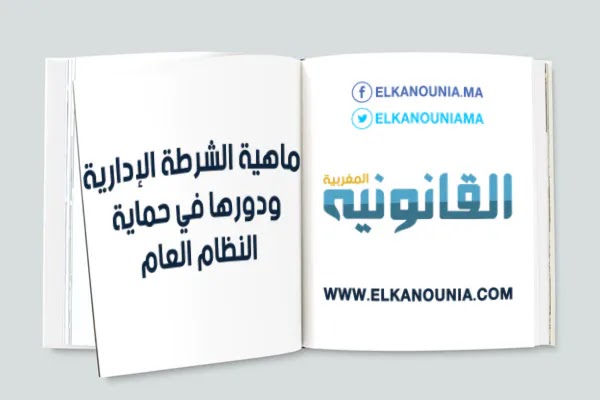
الضبط الإداري، الشرطة الإدارية أو البوليس الإداري إحدى الدعامات الرئيسية التي تقوم عليها وظيفة الإدارة العامة، التي تعمل على إشباع حاجيات الأفراد بتقديم أفضل الخدمات لهم.[1]
لذلك يفضل الأستاذ عبد القادر باينة مفهوم الضبط الإداري الذي يستعمله الفقهاء في الوطن العربي ويعتبره أقوم على تعبير الشرطة الإدارية، التي لا تقتصر على مفهوم السلطة أو الردع، بل تؤكد أيضا على التنظيم وضبط النشاط الإداري والحياة العامة بالبلاد وتوجيه نشاط المواطنين في نطاق الصالح العام يعني في إطار الحفاظ على النظام العام.[2]
ففي الوقت الذي كانت أغراض سلطة الضبط الإداري مقتصرة على إشاعة الأمن العام والصحة العامة والحفاظ على السكينة العامة وراحة عموم الناس، شهدت نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تطورات كبيرة مما استوجب تدخل الدولة الفاعل، لتنظيم حريات الأفراد التي بدورها تعددت مناحي نشاطاتها وتنوعت أشكالها، لهذا فإن تدخل سلطة الضبط الإداري لتحقيق مصالح المجتمع العليا والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام أصبح ضرورة لا مناص منها.
إن الضبط الإداري والشرطة الإدارية أو البوليس الإداري هو نشاط ومظهر من مظاهر عمل الإدارة تهدف من خلاله الحفاظ على النظام العام أو إعادته لنصابه عند اختلاله من خلال الوسائل والأساليب المقررة لها قانونا، ويقتضي ذلك منحها الإدارة العديد من الامتيازات اللازمة لتحقيق الغاية المذكورة، إلا أن تلك الامتيازات لا يمكن أن تكون غاية بحد ذاتها، بقدر ما هي وسائل يمكن لسلطة الضبط الإداري من خلالها أن تقوم بأداء مهامها بفاعلية ونشاط .
غير أنه وبسبب الارتباط المباشر النشاط الضبط الإداري بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فإن ذلك يمكن أن يرتب أثره تجاه سلطة الضبط الإداري بحيث لا يمكن أن تكون لها حرية مطلقة عند أداء مهامها، دون حدود و قيود بل يجب عليها التقيد بإجراء الموازنة بين متطلبات المحافظة على النظام العام كونه يمثل غاية الضبط الإداري من جهة واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من جهة أخرى حتى وان تطلب ذلك تنظيمها لممارسة الأفراد لتلك الحريات تفاديا للتهديد الحاصل بالنظام العام.
وحيث أن فكرة النظام العام، فكرة مرنة ونسبية ومتغيرة من زمان لأخر ومن مكان الآخر، بحيث لا يمكن تحديد ماهيتها ضمن مفهوم محدد سلفا في النصوص القانونية أو الأحكام القضائية، فإنه قد يفسح المجال أمام سلطة الضبط الإداري في التعسف بالسلطة الممنوحة لها لفرض المحافظة على النظام العام، بشكل قد يرتب آثاره السلبية تجاه حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، من خلال المساس بها أو تقييدها دون مبرر قانوني خاصة وان عناصر النظام العام لم تعد قاصرة على العناصر التقليدية لها والمتمثلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة بل أصبحت شاملة في الوقت الحاضر لعناصر أخرى، كالنظام العام المعنوي (الأخلاق العامة) والنظام العام البيئي (جمال الرونق والرواء) والنظام العام الاقتصادي. [3]
وفي هذا الصدد، فإننا سنتطرق في هذا المقال لتأصيل فكرة الضبط الإداري من خلال التطرق لطبيعة الضبط الإداري في المطلب الأول و انواعه وعلاقته ببعض الأنظمة المشابهة له في المطلب الثاني ثم اهدافه في المطلب الثالث.
المطلب الأول : تأصيل فكرة الضبط الإداري
والسلطات العمومية هي المكلفة بالحفاظ على النظام العام وكل دولة لا تستطيع الحفاظ عليه فلا يمكن أن تعتبر دولة قادرة على القيام بمسؤولياتها من اجل حماية مواطنيها وسلامة الدولة نفسها .
لما كانت سلطة الضبط الإداري تطال مجالات شتى، فقد تباينت آراء فقهاء القانون في تناولهم لطبيعتها، إذ رأى قسم منهم أنها سلطة قانونية محايدة (الفقرة الاولى) في حين عدها آخرون سلطة ذات طبيعة سياسية (الفقرة الثانية) بينما أكد رأي آخر على الطبيعة المزدوجة لسلطة الضبط الإداري (الفقرة الثالثة).
الفقرة الاولى: الضبط الإداري سلطة قانونية محايدة .
ويمثل هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي الفقيه (ber nard)، والذي ينكر وجود نظام عام سياسي مستقل يكون مبررا لوجود سلطة ضبط سياسية، على اعتبار أن هناك فروقا جوهرية بين السلطتين الإدارية والسياسية، وأن السلطة الإدارية كقاعدة عامة لابد من أن تكون بمنأى عن المؤثرات السياسية داخل الدولة الأمر الذي يترتب عليه عدم ارتباط النظام العام بالنظام السياسي، ومتى حصل ذلك فإنه يؤدي إلى انتفاء الصفة القانونية عن فكرة النظام العام التي تمثل غاية الضبط الإداري، ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه (ULman) والذي أكد على الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الإداري، إلا أنها، حسب هذا الرأي، قد تتحول إلى طبيعة سياسية متى ما حصل انحراف باستعمالها من قبل الأشخاص القائمين بها.
أما في الفقه العربي فقد ذهب ذ. محمود سعد الدين الشريف إلى إيضاح الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الإداري من خلال تمديد الخصائص المميزة لهذه الفكرة، كونها ضرورية، كما تصنف بكونها حيادية، إضافة إلى خضوع وظيفة الضبط الإداري لسيادة القانون ورقابة القضاء الإداري، كونها تمثل نشاطا إداريا يستمد شرعيته من النصوص الدستورية والتشريعية، وأخيرا ما تتميز به هذه الوظيفة هو اعتمادها على وسيلة السلطة العامة في المحافظة على النظام العام.
الفقرة الثانية: الضبط الإداري سلطة سياسية
لذلك فإنه إذا كان هنالك حدا لا يختلف من مجتمع لأخر ضمن نطاق النظام العام والمتمثل في تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، فإن هناك حدا آخر يختلف بين المجتمعات ويتعلق بحماية النظام السياسي في الدولة، ويبرز ذلك بصورة واضحة في الرقابة القضائية على سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري والقيود التي تفرض على الحريات العامة بإدعاء حماية النظام العام، رغم أنها تفرض حماية السلطة الحاكمة في الدولة.
ولغرض تأكيد الطبيعة السياسية للضبط الإداري فقد ذهب الفقيه باسكو إلى أن الضبط الإداري ما هو إلا سلطة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة، وتملك هذه السلطة في سبيل تحقيق غايتها، الحق في إجبار الأفراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة.
وانتقد أصحاب هذا الاتجاه الرأي القائل بالطبيعة القانونية المحايدة للضبط الإداري، على اعتبار أن ذلك يعد ضربا من الخيال، ولا يمكن أن يوجد إلا في المجتمعات المثالية، ومن الناحية النظرية حيث أن الواقع العملي يشير إلى خلاف ذلك، باعتبار أن الطبقة الحاكمة هي التي تفرض النظام الذي يمكن لها من خلاله البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وقد تعرض هذا الرأي العديد من الانتقادات:
الفقرة الثالثة: الطبيعة المزدوجة للضبط الإداري
ويربط أصحاب هذا الرأي بين طبيعة الضبط الإداري من جهة وغايتها من جهة أخرى، حيث أن وظيفة الضبط الإداري في كافة الدول، ديمقراطة كانت أو ديكتاتورية، إنما تهدف إلى ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة، والحيلولة دون إساءة استعمالها بشكل لا تكون معه مضرة بحريات الآخرين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المانعة لارتكاب الجرائم الجنائية، والعمل على حماية النظام العام بعناصره التقليدية من امن عام وصحة عامة وسكينة عامة.
وتكتنف هذه الوظيفة طبيعة قانونية حيادية وفق مبادئ الحياد الوظيفي دون أية شبهة سياسية، وهذا بخلاف ما هو عليه الحال عندما يكون الغرض من ممارسة الضبط الإداري الوظيفة سياسية أو لغرض منع ارتكاب جرائم سياسة، وهي التي تنصب عادة على أمن الدولة أو تتعلق بنظامها السياسي إذ يعمد النظام السياسي عادة على إصدار العديد من القوانين التي تحقق له الطمأنينة السياسية وعندها فلا يمكن القول بغير الطبيعة السياسية الضبط الإداري.
وبالعودة إلى سلطات الدولة التقليدية نجد توافر هذه المقومات فيها، فقد اعترف بها الدستور، ولها من الهيئات ما تستطيع تنفيذ ما يلقى على كاهلها من مهام وواجبات، بلا تدخل سلطة أخرى ولاسيما في الأنظمة الديمقراطية.
المطلب الثاني: الضبط الإداري و الأنظمة المشابهة له.
لذلك سنتطرق لتمييز الضبط الإداري عن بعض الأنظمة المشابهة له، من خلال التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي في الفقرة الاولى ، والتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي في الفقرة الثانية، والتمييز بين الشرطة الإدارية والمرفق العام في الفقرة الثالثة .
الفقرة الاولى: الضبط الإداري والضبط التشريعي
أما الضبط التشريعي يشمل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تحدد وتضبط وتبين كيفيات ممارسة الحريات الواردة في الدستور ذلك أن معظم تلك الحريات تقتضي سن قوانين متعلقة بها.
الفقرة الثانية: الضبط الإداري والضبط القضائي
أولا: أهمية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي
في مصر، فإن القضاء المصري بالرغم من إضفاء صفة الأعمال القضائية على أعمال الضبطية القضائية، إلا أنه قد اتجه منذ البداية إلى تقرير مسؤولية الدولة عنها[8] وفي المغرب وحسب المادة 122 من الدستور فهي تنص على حق "كل متضرر عن خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة " فإن الأعمال القضائية أصبحت شأنها شأن الأعمال الإدارية من حيث إمكانية انعقاد مسؤولية الدولة عن وقوع خطأ من المرفق الصادر عن العمل"[9].
ثانيا: معايير التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي
غير أن التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي على النحو المذكور لا ينفي وجود تداخل بينهما خصوصا عندما يتم إسناد هما لنفس الشخص، فالعمال والباشوات والقواد مثلا يقومون في نفس الوقت بمهام الضبط الإداري بصفتهم ممثلين للسلطة الإدارية المركزية، ويسهرون على تطبيق القوانين والحفاظ على النظام العام ويمارسون مهام الضبط القضائي استنادا على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، نفس الشيء بالنسبة لرجال الأمن والدرك والسير على الطرقات، كما يمارسون مهام الضبط القضائي عندما يقومون بالتحقيق والبحث والقبض على الجناة [11].
وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص على المعيار الموضوعي، وذلك بالنظر إلى طبيعة وموضوع الإجراء الضبطي ومن ثم إذا كـان الإجراء الضبطي، قد اتخذ بصدد جريمة محددة بقصد جمع الاستدلالات أو البحث عن المجرمين والقبض عليهم لتقديمهم إلى العدالة، فإن الإجراء في هذه الحالة يعد من قبيل إجراءات الضبط القضائي، أما إذا كان الإجراء الضبطي لا يواجه جريمة معينة وإنما اتخذه رجل الضبط بقصد حماية النظام العام، فإن الإجراء في هذه الحالة يعتبر من إجراءات الضبط الإداري.
ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي أخذت بهذا المعيار حكمه الصادر في 11 مايو 1951 في قضية « BAUD » ثم الحكم الصادر فــــــي 24 يونيو 1960 في قضية FRAMPAR [13].
رغم هذه المعايير السابق ذكرها، لم تزدد محاولة التمييز بين الشرطتين إلا تشعبا كما تعددت الآراء والاتجاهات بخصوصها، وفي هذا السياق حاول البعض البحث عــــــن عناصر التمييز بينهما من خلال اعتماد عنصر من العناصر التي تبدو في نظره وجيهة. من بين هذه العناصر نجد:
الفقرة الثالثة : الشرطة الإدارية والمرفق العام
أجمع معظم الباحثين على ضرورة التمييز بين الشرطة الإدارية والمرفق العمومي داخل الوظيفة الإدارية، حيث اعتبر مارسيل واكين بان الشرطة الإدارية و المرفق العمومي مختلفين للتدخل مختلفين ومتناقضين فيما بينهما، ومن جهته اعتبر العميد فيديل بأن التعارض يتجلى في كون أن النمط العادي للشرطة هو إصدار الأوامر بينما النمط العادي للمرفق العمومي هو إرساء الخدمات معترفا بأن هذا التعارض يبقى نسبيا[15].
إن الأخذ بفكرة المرفق العام يتعارض مع النشاط الفردي، فحيث ما يوجد مرفق عام يصبح هذا النشاط محكوما بصفة جزئية أو كلية بالقانون العام القانون الإداري وبالعكس فإن تدخل الشرطة الإدارية ينصب على النشاط الذي يمارسه الأفراد والذي يعتبر بطبيعة الحال نشاطا خاصا، وهذا يبرز الخلاف ما بين الشرطة الإدارية من جهة والمرفق العام من جهة ثانية على اعتبار أن كلا منهما يتجه إلى أسلوب يختلف عن الأسلوب الأخر.
فعندما تتدخل الإدارة عن طريق اتخاذ تدابير شرطية تفرض قيودا على حريات الأفراد ونشاطهم بهدف حماية النظام العام، فهذا أسلوب الشرطة الإدارية أما عندما تتدخل مباشرة لإشباع حاجيات المواطنين إما بنفسها أو عن طريق الغير وتقديم خدمات لهم سواء كانت مجانا أو بمقابل نظرا لعجز الأفراد عن إشباعها بأنفسهم أو لعدم توفرهم على الإمكانيات المالية أو الفنية أو لعزوفهم عن القيام بها لأنها لا تدر ربحا أو غير ذلك من الأسباب فإن هذا هو أسلوب المرفق العمومي [16].
بناء على هذا التمييز يتضح أن الفرق بين الشرطة الإدارية والمرفق العمومي يكمن في أن الأولى تدخلها سلبي، وأداتها الأساسية هي وضع التنظيمات التي هي عبارة عن أوامر أو نواهي بينما الثاني وهو المرفق العام تدخله يتميز بالإيجابية أي تقديم خدمات معينة للمواطنين. وهنا يثور التساؤل عن خطوط التماس بين الشرطة الإدارية والمرفق العام؟
والجواب عن ذلك هو أنه يوجد بهذا الصدد مذهبان في تكييف العلاقة بينهما يختلف كل منهما عن الأخر وهما مذهب الوحدة، ومذهب الازدواجية.
فمذهب الوحدة، يعتبر أنصاره أن فكرة المرفق العمومي، هي أساس القانون الإداري ومعيار تطبيقه، لذا يقول العميد دوكي، أن نشاط الضبط الإداري هو في جوهره مرفق عمومي، وقد برر توجهه هذا بكون السعي نحو تحقيق المصلحة العامة هو الهدف الذي ينبغي الوصول إليه، وبرأيه فإن كلا من الشرطة الإدارية والمرفق العمومي يسعيان إلى تحقيق المصلحة العامة، إذ هما شيء واحد.
أما مذهب الازدواجية فإن أنصاره يضعون التمييز بين الشرطة الإدارية والمرفق العمومي من ناحية وجود تعارض نسبي بين ما الإجراءات التي يمارس بها كل منهما نشاطه.
إن التمييز بين المرفق العام والشرطة الإدارية من الصعوبة بمكان في نظر بعض الباحثين، وكل الآراء التي قيلت حول موضوع العلاقة بينهما رغم جديتها وعمقها لم تحسم في الموضوع، وكل ما وصلت إليه هو تقديم محاولة للتذليل على تحديد مهمة الشرطة الإدارية تجاه المرفق العامة[17]، وبناء عليه فإنه من الصعوبة بمكان الجزم بأن هنالك حدا فاصلا بين المرفق العام والشرطة الإدارية يمكن الركون إليها وأن التمييز بينهما على كل ما هنالك آراء أطلقها بعض الفقهاء القانون الإداري محاولين إيجاد صيغة مقبولة تختلف باختلاف النظر إلى كل من المرفق العام والشرطة الإدارية يمكن الركون إليها لتقريب وجهات النظر بخصوص التمييز بين المدلولين. ويمكن تلخيص وجهات النظر تلك فيما يلي:
الشرطة الإدارية تشكل في نظر البعض مرفقا عاما في مدلول إطلاق المصالح الإدارية للدولة، والتي تعتبر كلـــها مؤسسات تابعة لها، كيفــــــما كانت المسميات التي تطلق عليها كمصلحة الأشغال البلدية، المكتب الصحي البلدي، مصلحة النظافة[18] وجمع النفايات، مصلحة الرقابة المدنية.. الخ، من هذا المنظور فإن الدولة تتكون من عدد من المصالح كل واحدة تعمل في ميدان معين ومنها جميعها تتفرع المرافق العمومية.
انطلاقا من هذا التوجه، فإن الشرطة الإدارية مثلها مثل المرفق العام تتحول إلى النظام العام، وهي بهذا تلتقي مع المرفق العام الذي يتمظهر أيضا كمؤسسة من مؤسسات الدولة يقدم خدماته للمواطنين، وبناء عليه فإن الشرطة الإدارية حسب هذا المفهوم مشابهة للمرفق العام من الوجهة التنظيمية المؤسساتية.
الشرطة الإدارية تؤدي نفس الغرض الذي يؤديه المرفق العام، بمعنى المصلحة العامة إذ لا ننسى أن تعريف المرفق العام بصفة عامة، هو نشاط يرمي لخدمة الصالح العام دون الخوض في تحديد أسلوب إرضاء تلك الحاجيات.
من جهة أخرى يعتقد البعض أنه من غير الممكن بناء على هذا التصور القول أن الشرطة الإدارية مرفق عام إذا ما اعتبرنا تعريف هذا الأخير والذي يوصف بالخدماتي أي أنه عمل إيجابي، بينما يمتاز نشاط الشرطة الإدارية بالتقنين وهو بطبيعة الحال عمل سلبي أو بعبارة أخرى إن تدخلها بطبيعته تدبير. يحد من نشاط الأفراد.
وهذا العمل السلبي الذي تقوم به الشرطة الإدارية والمقيد لنشاط الأفراد هو نفسه الفضاء الطبيعي الذي يمارس في إطاره المرفق العام نشاطه حسب التنظيمات المعمول بها المقننة لمزاولة أي نشاط خاص[19].
إلا أنه ورغم ما ذكر فإن الفرق ما بين المرفق العمومي والشرطة الإدارية يمكن التوصل إليه حسب رأي الأستاذ محمد الأعرج استناداإلى القاعدة التي تؤكد بأن المرفق العام يمكنه اللجوء إلى تقنية العقود، في حين أن الشرطة الإدارية لا يمكن تفويتها إلى الأشخاص الخاصة[20].
وأخيرا وفي إطار هذه الفقرة، وجب التمييز بين الشرطة الإدارية والسلطة التنظيمية فهذه الأخيرة وسيلة قانونية يرتكز عليها عمل الشرطة في حين أن الشرطة الإدارية عمل من أعمال الإدارة[21].
المطلب الثالث : أهداف الضبط الإداري وأنواعه
تضع السلطات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية قيودا على حريات الأفراد وحتى لا يترك المجال لهذه السلطات لتعصف بهذه الحريات تحت ستار المحافظة على النظام العام، كان لزاما تحديد أهدافها وغاياتها.
وعليه فإن سلطات الضبط الإداري ليست سلطات مطلقة بل مقيدة من جهة ما ورد في الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية ، ومن جهة أخرى مقيدة بهدف المحافظة على النظام العام، وإذا انحرفت سلطات الضبط الإداري عن تحقيق هذا الهدف اعتبر تصرفها مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة.
وهكذا تخضع سلطات الشرطة الإدارية لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا[22]. وتعتبر حماية النظام العام بمدلولاته المتعارف عليها، الهدف الأساسي من وظيفة الشرطة/الإدارية فليس لهيئات الشرطة الإدارية استخدام سلطاتها من أجل تحقيق أهداف أخرى غير ذلك ، وان تعلق الأمر بالمصلحة العامة لأن أهداف الضبط الإداري هي أهداف مخصصة ليس للإدارة أن تخرج عليها، وذلك باعتبار أن فكرة النظام العام فكرة لصيقة بالمجتمع مما يجعلها تشكل ضرورة حيوية لتدخل سلطة الضبط الإداري بهدف وقاية المجتمع وتحقيق أمنه وسكينته، وبذلك تمثل السند الأساسي والشرعي لتلبية حاجيات المجتمع من استقرار وسلام كما يخولها سلطة تنظيم نشاط الأفراد في المجتمع بما يسمح للجميع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم من جهة والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى[23].
وقد وجد الفقهاء صعوبة في وضع تعریف جامع ومانع للنظام العام، ذلك لأن مفهومه لا يتصف بالثبات ولكونه يتغير بتغير الزمان والمكان بحسب طبيعة النظام السياسي السائد، كون فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتطورة، وكل ما يستطيع المشرع أن يفعله هو أن يعرفها من خلال مضمونها فحسب تاركا المجال للقضاء والفقه لتحديد التصرفات التي تعد مناهضة للنظام العام [24].
وعلى هذا الأساس فإن النظام العام ينصرف في مدلوله التقليدي إلى المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، ويلاحظ على هذا المضمون الضيق لفكرة النظام العام التقاؤه مع الفكر الليبرالي التقليدي الذي لا يقبل تدخل الدولة إلا في أضيق الحدود.
ولقد ظل القضاء الإداري الفرنسي متمسكا بهذا المضمون الضيق لفكرة النظام العام لمدة طويلة، إلا أنه عدل عن ذلك جراء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي سادت العالم وأثرت على مفاهيم المذهب الليبرالي نفسه، فخول الإدارة التدخل بإجراءات الضبط في مجالات أوسع لم يكن يتيحها قصر مضمون النظام العام على العناصر التقليدية الثلاثة المتعارف عليها[25]، كحماية الأخلاق الحميدة والآداب العامة وجمالية المدينة والكرامة الإنسانية . هكذا سنتناول أهداف الضبط الإداري من خلال التعريف بمدلول فكرة النظام العام وعناصره في (الفقرة الاولى) والأهداف الحديثة المعتبرة من مدلولات النظام العام في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مدلول فكرة النظام العام وعناصره
أولا: مدلول فكرة النظام العام
النظام العام فكرة قانونية يتجاوز بكثير نطاق الضبط الإداري وتتغلغل في ثنايا النظرية العامة للقانون، فهو من ناحية يعد حالة يسود فيها الترتيب المتناسق للعلاقات الاجتماعية، ومن ناحية أخرى يعني التعبير عن بعض القواعد القانونية الملزمة التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو نقضها، ويجب على القاضي ترجيحها إذا ساد الصمت أطراف العلاقة القانونية [27].
ولهذا لا يملك المشرع أن يحدد لها مضمونها ولا يعرفها على وجه محدد، فيشوه طبيعتها ويمنعها من أن تؤدي وظيفتها بحيث ترك للفقه والقضاء أمر تحديد التصرفات التي تعد مناهضة للنظام العام [28].
وقد ظهرت فكرة النظام العام في صورتها القانونية من خلال إعلان الثورة الفرنسية الذي قضى بمبدأ المساواة، واعتبرت أن كل اتفاق يهدف إلى المساس بالمبادئ الكبرى لا يعتبر مخالفا للنظام العام[29].
للنظام العام مفاهيم متعددة وفقا للاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية[30]. في المجال الفقهي برزت عدة تعريفات النظام العام، وذلك من خلال التركيز على انعكاس سلطة الضبط على النشاط والحرية، ومن خلال التقيد أو من خلال ربط التعريف بالعوامل المؤثرة في المجتمع[31].
في هذا الصدد وفي الفقه الفرنسي، يعرفه الأستاذ هوريو بأنه" النظام المادي المحسوس والذي يعتبر بمثابة حالة مناقضة للفوضى" أما الفقيه فالين Walin فعرفه بأنه " مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين الأفراد، وعلى ذلك فإن النظام العام يتسع ليشمل الجانب الأدبي أو المعنوي إضافة للجانب المادي[32].
وفي الفقه الإداري العربي عرف خالد خليل الظاهر النظام العام بأنه "المفاهيم والعقائد التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية السائدة في الدولة مع حركات تطور ظروف الزمان والمكان [33]، ويعرفه الدكتور زين العابدين بركان بقوله " النظام العام بمعنى المحافظة على الأمن العام والراحة العامة والسلامة العامة، وعلى ذلك يدخل ضمن أغراض الضابطة الإدارية كلما دعت الضرورة للمحافظة على النظام العام " [34].
وفي المجال القضائي وفي فرنسا فقد كتب مفوض الدولة le tour neur "في تقرير له يقول فيه " بأن النظام العام فكرة مبهمة إن غموض غائية النظام العام و الطابع الظرفي له يأتيان من تعدد المقتضيات التي تهدده، بل عليه أيضا أن يحمي الفرد من الأخطار التي لا يمكنه هو نفسه استبعادها سواء كان مصدرها أفرادا آخرون، أم كان مصدرها حيوانات أم ظواهر اجتهادية، لذلك ليس من الممكن حصر تلك المقتضيات ذات المضمون المتغير داخل صيغة محددة، إن تلك الحقبة قد أدركها القضاء تماما[35]. لا بد من إعادة النظر في هذه الفقرة غير المفهومة.
اتجه القضاء الإداري الفرنسي أول الأمر إلى تبني الاتجاه القائم على التضييق من فكرة النظام العام بأن قصرها على الجانب المادي فقط بدون جوانبه الأدبية أو المعنوية، إلا أن نقطة التحول في قضاء هذا المجلس يتمثل في حكمه الصادر بتاريخ و 18ديسمبر1959 في قضية لوتيسيا(LUTETIA) [36]. حيث تواترت أحكام المجلس المذكور على الإقرار بالنظام العام المعنوي أو الأدبي، بشكل مستقل عن النظام العام المادي، بل توسع إلى أبعد الحدود في تفسير فكرة الآداب العامة نفسها حيث قضى في قراره المؤرخ في 1995/10/27 إلى أن كرامة وشرف الإنسان. الأدبي تشكل إحدى عناصر النظام العام.[37]
هذا وتجدر الإشارة وبالعودة إلى بعض النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام في القانون المغربي منذ سنة 1960 التي نظمت مهام الشرطة الإدارية ، استعملت تعابير مختلفة عند الحديث عن العناصر المكونة للنظام العام من نص لأخر كتعبير الهدوء [38] النظام العام والصحة وذلك لإثارة نوع من الغموض بهدف ترك هامش واسع للإدارة وحرية أكبر لاتخاذ القرار المناسب وهي في ظرف يسمح لها بسلطة تقديرية هامة [39].
ثانيا : عناصر النظام العام
ولهذا السبب تتدخل الهيئات الإدارية التي تملك سلطات الشرطة الإدارية لمنع أي نشاط يضر أو يؤثر على السكينة العامة، أو منع أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالسكينة العامة للمجتمع [44].
غير أن القضاء الفرنسي قد أجاز في فترة لاحقة لسلطات الضبط التدخل لحماية القواعد الأخلاقية الأساسية ولو لم يترتب على الإخلال بهــــا تهديد بالاضــــطراب المادي، وكان ذلك في حكمه الشهير في قضية «LUTETIA » سنة 1959 حيث اعترف مجلس الدولة في هذا الحكم بسلطة العمدة في أن يحظر عرض أفلام سبق أن أجازتها هيئة الرقابة على الأفلام ، إذ كان من شأن عرضها ، بسبب طابعها اللااخلاقي والظروف المحلية، أن يضر ذلك بالنظام العام، وبعبارة أخرى، أن لا أخلاقية الفيلم شكل دافعا صحيحا للمنع، ولكن يشترط أن تكون مصحوبة بظروف محلية[47].
وقد سار على خطاه القضاء المغربي إذ ذهب في نفس الاتجاه وأخذ بمبدأ التوسع في : مفهوم النظام العام وأصدر بعض الأحكام المؤيدة لهذا الموقف، حيث قرن بين الأخلاق الحميدة والنظام العام منها على سبيل المثال، الحكم الصادر بتاريخ 22 يونيو 1964 في قضية المدعو أحمد واكريم والحكم الصادر بتاريخ 19 يونيو 1962 في قضية حمو دافيدو أيضا الحكم الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1985 والذي جاء فيه ما يلي: "إن الإدارة وان كان لها الحق في منع بيع أي منشور إلا أن ذلك يجب أن يكون مبررا قانونيا بمعنى أن يكون الهدف من ذلك استعمال حق الرقابة للحفاظ على الأخلاق والنظام العام[48].
أو النظام الذي يهدف إلى حماية جمال الرونق والرواء للبيئة حفاظا على السكينة النفسية للأفراد المقيمين في هذه البيئة[50].
تعد المدينة تجمعا حضريا لعدد كبير من السكان على ارض واسعة نوعا ما لذا كان لابد من الاهتمام بتنظيم المدينة والعمل على تجميلها مما يتوافق مع آراء فقهاء القانون، إذ وضعوها ضمن الأغراض غير التقليدية لسلطة الضبط الإداري مما استدعى ضرورة اتخاذ سلطات الضبط الإداري إجراءات وتدابير بغية الإبقاء على جمال المدينة المتمثل في تنسيق أحيائها وشوارعها وأزقتها باستحضار مواصفات معينة للمباني السكنية والعمارات، والعمل على زراعة الميادين وتقاطعات الطرق وحماية الميادين الأثرية والتراثية وإشاعة أجواء من النظافة والتنسيق مما تولد المتعة بجمال المدينة وبهائها، لأن هذا الجمال بدون الاستفادة من التطور المعماري وتوفير السكينة والارتياح النفسي لا يكفي في حد ذاته.
فهنا تبرز المسؤولية المباشرة للإدارة التي تناط بها واجبات حماية المواطن الذي يتذوق جمال مدينة ويعمل جاهدا على سلامتها والمحافظة عليها بكل غال ونفيس[51].
لقد كان مجلس الدولة الفرنسي في أول الأمر لا يعترف بحق سلطات الضبط الإداري في حماية الرونق والرواء وأيد هذا الاتجاه بعد ذلك ، في حكمه الصادر بتاريخ 1946 عندما اقر بمشروعية قرار يحذر توزيع منشورات على المارة في الشوارع العمومية خشية إلقائها في الطرقات بعد قراءتها مما يشوب رونقها ويخل بجمال منظرها[52]، إذ أشار الحكم صراحة إلى حق سلطة الشرطة الإدارية في اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها ضرورة المحافظة على النظام والصحة العامة والسكينة وجمال الرونق على انه اشترط لذلك أن يصل مستوى المساس بجمال الرونق درجة من الخطورة وأن يكون من شأنه إثارة اضطرابات داخلية.
وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على الاعتراف لسلطة الضبط الإداري وضمن حدود معينة من التدخل لحماية النظام العام الاقتصادي إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بقراره المؤرخ 22 ديسمبر 1949 بأن المحافظ يستطيع أن ينظم فتح مخازن الخبز وأن يحضر نقله إلى المنازل في نطاق السياسية العامة للتغذية وأن العمدة يملك لحماية مصالح المستهلكين أن يفرض التدابير الملائمة لمنع نقص المواد الأولية وكذا الارتفاع الوهمي للأسعار[54].
الفقرة الثانية: خصائص النظام العام
أولا: قيام النظام العام على أساس قواعد قانونية آمرة
ثانيا: النظام العام ليس من صنع المشرع وحده
ثالثا: النظام العام فكرة مرنة ومتطورة ومتغيرة باستمرار
وهذا ما يبرر استبعاد حصر النظام العام في النصوص القانونية، فكل ما يستطيع المشرع فعله هو تركه للقضاء والفقه أمر تحديد التصرفات التي تعد مناهضة للنظام العام لهذا فإنه من الصعوبة حصر عناصر النظام العام بشكل محدد لأن التحديد وإن كان صحيحا بالنسبة لفترة معينة، إلا أنه يخضع لتطور مستمر[58].
رابعا: ارتباط فكرة النظام العام بنطاق التفسير القضائي .
الفقرة الثالثة: أنواع الضبط الإداري
والضبط الإداري العام من حيث الأشخاص المعهود إليهم بمزاولته ينقسم إلى ضبط وطني، والمقصود به السلطات الممارسة للشرطة الإدارية على التراب الوطني برمته ويمارسه بكيفية أساسية الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)، والضبط الإداري المحلي أي مجموعة السلطات المحلية الممارسة للشرطة على جزء محدود ومعين من إقليم الدولة كالجهة والإقليم والعمالة والجماعة وتدخل في اختصاص عامل الجهة بالنسبة[60] للجهات وعامل الإقليم وبالنسبة للأقاليم ويتقاسمه القائد والباشا ورئيس الجماعة الحضرية أو القروية بالنسبة للجماعة.
ورغم أن هدف الشرطة الإدارية بصفة عامة واضحا وهو الحفاظ على النظام العام في مفهومه الواسع، وفي إطار التمييز بينهما اجتهد الفقه في تقديم عدة معايير إلا أنه لا يوجد ثمة اتفاق على معيار معين، لكن يمكن إجمال المعايير التي تم الاتفاق عليها فيما يلي:
أولا: المعيار العضوي أو القائم على أساس المعيار الموضوعي
غير أن هذا المعيار يبدو أنه غير مقنع وذلك لما ينطوي عليه من عامل ازدواجية ممارسة الشرطة الإدارية مما لا يضفي على معيار العضو بأي صفة مميزة بين الشرطتين[62] .
ثانيا: التمييز على أساس المعيار الترابي
ثالثا: التمييز على أساس الغاية أو الهدف
رابعا: معيار الأساليب المستخدمة
خامسا: المعيار التوفيقي
الحالة الأولى: أن يمنح المشرع صراحة سلطات الضبط الإداري العام من التدخل في اختصاص الضبط الإداري الخاص، ومثال ذلك تنظيم المشرع الفرنسي لضبط السكك الحديدية بنصوص مفصلة تواجه كل ما يعرض النظام العام في مناطق السكك الحديدية للخطر وتعهد بها إلى هيئات الضبط الإداري الخاص.
الحالة الثانية: أن يرد كل من الضبط العام والضبط الخاص على أوجه من النشاط لا يهتم بها الأخر أو لان ما يعالجه الضبط الخاص لا يغطي كافة النواحي التي يستهدفها الضبط العام ، وهنا يمكن للضبط الإداري العام أن يتدخل ليكمل الضبط الإداري الخاص، غير أن هذا التداخل يجب أن يكون له ما يبرره من ظروف الزمان والمكان، مثال ذلك أن تحظر سلطة الضبط الإداري العام في بلدة ما عرض فيلم سينمائي أجازته سلطة الضبط الخاص بالرقابة على المصنفات الفنية التي يمتد اختصاصها ليشمل كل إقليم الدولة، وذلك لاحتواء الفيلم على السخرية من أبناء البلدة لكونها مقرا لاماكن عبادة.

